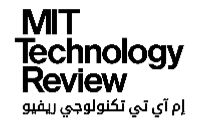كان “آيفون إكس” بلا شك نجم العرض دون منازع خلال حفل “آبل” لكشف النقاب عن المنتج اللامع العام الماضي. يُعد نظام الأمان الجديد القائم على التعرف على الوجوه، “فيس آي دي” (Face ID)، في هذا الجهاز الأنيق أحد أكبر مصادر الفخر للشركة المنتجة. إذ بدلاً من مطالبة المستخدم باستعمال بصمة إصبعه على زر الصفحة الرئيسية غير الموجود حالياً لإلغاء قفل الهاتف، يستخدم برنامج “فيس آي دي” في جهاز آيفون كاميراته الخاصة لإجراء عمليات مسح ثلاثية الأبعاد لوجه المستخدم الذي يمكّنه عندئذ من إلغاء القفل عن طريق وضع الجهاز قبالة وجه المستخدم، فكيف ستغير تقنية التعرف على الوجوه المستقبل؟
مستوى الأمان في تقنية التعرف على الوجه
وخلال الحفل، تفاخر أحد المدراء التنفيذيين بمستوى الأمان الذي توفره تقنية التعرف على الوجوه، والذي يفوق أمان معرّف اللمس السابق الذي كان يعتمد على بصمة الإصبع، بدعوى أن احتمالية تمكن وجه غريب عشوائياً من إلغاء قفل جهاز المستخدم لا يتعدى نسبة واحد في المليون فقط. فقد صوّر المستخدمون المتحمسون في جميع أنحاء العالم أنفسهم وهم يحاولون التلاعب على هذه الميزة الجديدة. لقد باءت جميع محاولاتهم تقريباً بالفشل سواء اعتمدت على استخدام أقنعة متقنة، أو مصادر متنوعة من الإضاءة، والمكياج، والأزياء، أو حتى التوائم الذين حاولوا التغلب على تقنية “فيس آي دي” دون جدوى بالنسبة لمعظمها.
ومع ذلك، فقد تتقلص الدعاية التي تحمل وعوداً مستقبلية بأن هذه التطبيقات الحديثة الأكثر تعقيداً لتقنية التعرف على الوجوه ستمنحنا الأمان بيسر. ففي سبتمبر/أيلول، على سبيل المثال، أصدر باحثان من جامعة “ستانفورد” دراسة زعمت بشكل غير حاسم إمكانية تنبؤ نظام تعلم آلي عما إذا كان أحد الأشخاص سوياً اعتماداً على صورة وجهه فقط، بنسبة دقة تصل إلى ما يتراوح بين 74 و81%. وفي الشهر نفسه، قدّم فريقٌ آخر من الباحثين الأكاديميين دراسة حول نظام تعلم آلي قالوا إنه قادر على تحديد هوية المتظاهرين المتخفّين خلف قبعات أو أوشحة بسيطة بمعدل نجاح يقرب من 69%. لا ننكر احتواء الدراستين على بعض العيوب ولكنهما أثارتا مخاوف مشروعة حول إمكانية استخدام تقنيات التعرف على الوجوه ضد الفئات الضعيفة مثل الأقليات والمعارضين السياسيين والفقراء.
ليس هذا بالأمر المثير للدهشة، إذ على الرغم من المظهر الثوري لهذه الإمكانيات، فإن فكرة التحليل التكنولوجي للوجوه ليست بالأمر الجديد سواء استُخدِمت لتأكيد الهويات أو إصدار الأحكام أو التنبؤ بالسلوك. وبدلاً من ذلك، يبدو أن الوجوه عادت لتشكل موضة رائجة من جديد تطغى على كل التقنيات الماضية. إذ على الرغم من استبعاد هذه التقنية خلال العقود الأخيرة (إذ تم استبعادها لاعتبارها علماً مزيفاً وعنصرياً، كما كان الحال مع علم الفراسة، أو ربما تراجع استخدامها بالمقارنة مع المقاييس الحيوية الأخرى، مثل بصمات الأصابع والحمض النووي). استثمر البشر خلال القرون الماضية كميات هائلة من الموارد في محاولة لاكتشاف أنماط ملامح البشر والتي نعتقد أنها تكشف شيئاً بالفعل عن أصحابها. لقد بات الوجه في خيالنا وكأنه رمز مرور متنقل للطبيعة البشرية ينتظر من يفكّ رموزه ليشرَحه.
يزعم مبتكرو أدوات التعرف على الوجه وتحليله اليوم أن تقنياتهم مختلفة. ونظراً لأن هذه الأدوات مدعومة من الكاميرات عالية التقنية والخوارزميات المتقدمة، فإنها تحمل وعداً بالدقة والموضوعية العلمية. لكن الماضي يقدم أمثلة تحذيرية لحدود مثل هذه الإسقاطات وتوضح كيف تغير مفهومنا للدقة، وكيف يمكن أن يؤدي استخدامنا أو سوء استعمالنا لأدوات التحديد هذه إلى تكاليف اجتماعية كبيرة.
لم يمتلك الأشخاص أجهزة متطورة للتعرف على بعضهم في معظم التاريخ البشري. وعلى الرغم من وضوح هذا الأمر، فإنه من المهم جداً في عصرنا الرقمي الراهن أن نتذكر الأهمية الكبيرة التي يحظى بها التفاعل وجهاً لوجه، والوجوه ذاتها، لأنها تشكل العمود الفقري للمجتمع الحديث. إن المكونات المتعددة للوجه البشري – أي المزيج غير المتناهي بين العضلات والأعصاب والتعبيرات، بالإضافة إلى فكرة احتوائه على مُعرّفات فريدة غير قابلة للتغيير (أي أكثر موثوقية من الأسماء أو التوقيعات أو الملابس أو اللوحات الإسمية) – عززت اعتمادنا عليها باعتبارها معايير مبكرة لتحديد الهوية والثقة.
لقد انعدمت الموثوقية في معرفة جميع الوجوه في أي مجتمع صغير بسبب النمو السكاني والتحضر الذي أعقب الثورة الصناعية. وسرعان ما أصبح العثور على مُعرّفات بديلة لتمييز الأفراد مسألة مرتبطة بالأمن سواء لدى المواطنين أو السلطات على حد سواء.
اعتماد الوجه البشري ككلمة مرور حيوية
لقد شكّل تحويل اللغات البصرية والشفهية للتعرف على الوجوه إلى لغة مكتوبة أول خطوة حاسمة في اعتماد الوجه البشري ككلمة مرور حيوية. يتّضح ذلك في بدايات ظهور جوازات السفر وفي الإعلانات التي تسعى للقبض على العبيد وخَدَم السخرة الهاربين. إذ اعتمدت الأوصاف المادية للوجوه في كليهما على فئات محددة سلفاً سعت إلى أن تكون موضوعية بما يكفي لتحديد الأفراد ضمن بحر من سكان المدن والمسافرين. فعلى سبيل المثال، كان وصف أحد خدم المنازل الهاربين في القرن 19 في جبال الأنديز على النحو التالي: “خوان، في العاشرة من العمر ذو وجه عادي. خلاسي اللون ذو شعر أسود أملس وعينان بنيتان وأنف صغير، له شفتن عاديتان، ولديه ندبة على جبهته”. وعلى الرغم من افتقار هذه الأوصاف إلى الدقة، فقد أصبحت أدوات تدعم كلاً من العالمية والاستعباد على حد سواء.
وتمثّلت المرحلة التالية من التقدم التكنولوجي في إيجاد طريقة لتمثيل الوجه البشري بشكل مرئي. تم استخدام الصور المرسومة باليد، لكنها لم تنتشر على نطاق واسع في تحديد الهوية إلا بعد اختراع التصوير الفوتوغرافي. وفجأة ظهرت آلاف الوجوه على الورق مع تزايد عدد الأشخاص الذين التقطوا صوراً لأنفسهم ليضعوها على بطاقات العمل من أجل توزيعها بين معارفهم أو الذين أُجبِروا على مواجهة الكاميرا بسبب الاشتباه بهم في مراكز الشرطة أو بصفتهم متقدمين للحصول على جوازات سفر.
كانت فكرة تجسيد شيء معقد مثل الوجه الإنساني على فيلم يبدو محايداً ظاهرياً (فالكاميرا لا تكذب!) نوعاً من الحلم التكنولوجي. اعتبر ضباط الشرطة صور الوجوه مثل أدوات يمكنها إحداث ثورة نوعية في إمكانية العثور على المشتبه بهم والقبض عليهم. وانتهز علماء الإجرام تقنية التصوير هذه لاستخدامها للنهوض بالنظريات التي تربط بعض السمات الجسدية بالسلوك المنحرف. كما تبنّت الحكومات استخدام الصور الفوتوغرافية كأداة تعريف عالية التقنية لاستخدامها في جوازات السفر وتصاريح العمل وبطاقات الهوية وغير ذلك.
وسرعان ما انتقلت الكاميرات من الاستوديوهات المغمورة للصور الفوتوغرافية إلى المكاتب البيروقراطية ومراكز الشرطة والسجون حتى تتمكن السلطات بسهولة من التقاط صور للمواطنين والمشتبه فيهم والمجرمين لوضعها في ملفاتهم. ولكن، على الأقل في البداية، لم تكن الصور مفيدة على النحو الذي تأمله السلطات. إذ تشتمل صور الوجوه اليوم على إرشادات قياسية متعارف عليها وصور أمامية وجانبية. لكن الصور في العصر الفيكتوري كانت أكثر فوضوية. إذ رفض السجناء التعاون. ما استدعى استعمال معدات ثقيلة كان لا بد من جلبها إلى أماكن التصوير وإعادة وضعها هناك لإرغامهم على الوقوف أمام الكاميرا. كما تباينت أساليب التصوير والتصنيف بين المؤسسات كثيراً، ما جعل تبادل المعلومات بين السلطات أمراً صعباً. بالإضافة إلى ذلك، كان بإمكان المجرمين الأذكياء تغيير مظهرهم الجسدي دائماً.
تقنية “برتيلوناج”
وفي هذا الوقت، ظهرت تقنية تعرف باسم “برتيلوناج” (bertillonage) واعدةً بنظام تعريفٍ حيوي معياري وسهل جداً. صمم هذه التقنية ألفونس بيرتيلون، ضابط في الشرطة الفرنسية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وشملت منهجيته، التي حملت اسمه، القياس الدقيق لـ 11 جزءاً من أجزاء الجسم، بما في ذلك طول الإصبع الأوسط، وطول الأذن اليمنى، وطول الرأس. واقترح إمكانية أن تخلق هذه المحددات، إلى جانب التصوير الفوتوغرافي، معرِّفاً فريداً لكل مشتبه به أو مجرم أو مهاجر – بحيث يمكن تخزين هذا المعرّف واستعادته واستعماله بسهولة. وسرعان ما اعتمده ضباط القانون باعتباره نظام تصنيف عالي التقنية.
شكّلت تقنية كان برتيلوناج اختراقاً مبتكراً من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فقد كانت كابوساً لوجستياً. إذ بحسب تفاصيل الرسم التخطيطي في كتيب هذه التقنية، كان لا بدّ للموظفين من ملاطفة الأشخاص الخاضعين لعملية القياس لاتخاذ وضعيات معقدة وضبط سلسلة من الأدوات لقياس كل جزء من أجزاء الجسم. ومع ذلك، وعلى الرغم من الصعوبات التقنية، فمن المستحيل ألّا نسجّل إعجابنا بالطموح الكبير لهذه الطريقة باعتبارها من أقدم أنظمة البيانات الضخمة التي تصنف مجموعة كبيرة من الوجوه والهيئات الفردية.
بعد فشل طريقة “برتيلوناج”، اتخذ التعرّف على الوجوه منحى تقنيات واعدة أخرى في مجال تحديد الهوية. وسرعان ما انتشر استخدام بصمات الأصابع ليكوّن تقنية التوثيق الحيوية المعتمدة لسلطات العدالة الجنائية في بادئ الأمر، ثم لأنظمة الأمن التجارية، وفيما بعد للأجهزة الرقمية الشخصية (بما في ذلك تاتش آي دي (Touch ID) سلف معرّف أبل المسمى فيس آي دي (Face ID). كما استقطبت المقاييس الحيوية الأخرى اهتماماً أيضاً، بما في ذلك الطرق التي تُصادق على هوياتنا من خلال أصواتنا وقزحيات أعيننا ورموزنا الوراثية وحتى من خلال طريقة مشينا.
استخدام تقنيات التعرف على الوجوه لمنع الاحتيال
وبحلول التسعينيات، بدأت بعض الوكالات الحكومية مثل إدارات الدولة للسيارات في دمج برامج التعرف على الوجوه لمنع انتحال الشخصية والاحتيال في استخراج رخص القيادة. لكن هجمات الحادي عشر من سبتمبر وما تلاها من “الحرب على الإرهاب”، والطريقة التي وسعت بها تكتيكات المراقبة الجماعية وغيّرتها، أعادت تحديد هوية الوجه واعتبارها وسيلة مفضلة لتحديد الهوية إلى ساحة الاهتمام. ووسعت السلطات المراقبة العامة بالفيديو وحللت مجموعات ضخمة من صور الكاميرات الأمنية وصور وسائل الإعلام الاجتماعية. كما استثمرت الحكومة الفيدرالية الأميركية بشكل كبير أيضاً في تطوير تقنيات جديدة ضمن هذا المجال. فعلى سبيل المثال، راهن “مكتب التحقيقات الفيدرالي” على نظامه من الجيل التالي لتحديد الهوية، وهو قاعدة بيانات يصفها بأنها “أكبر مستودع إلكتروني في العالم وأكثرها فاعلية لمعلومات التاريخ الحيوية والإجرامية”. ويتضمن نظاماً آلياً للبحث والاستجابة للتعرّف على الوجه من أجل مساعدة وكالات إنفاذ القانون. كما اتخذت وزارة “الأمن الداخلي” الأميركية، عدة خطوات لتوسيع برامج جمع بيانات مسح للوجه والقزحية للمسافرين الدوليين في المطارات.
بدأت الشركات الخاصة أيضاً في التنافس في سباقٍ يتعامل مع الوجه على أنه طريقة مصادقة عالية الدقة، وآمنة للغاية. فإلى جانب شركة “آبل”، برزت شركة “فيسبوك” بصفتها رائدة في تقنية التعرّف على الوجوه. إذ تدرّب شركة وسائل الإعلام الاجتماعية خوارزميتها “ديب فيس” (DeepFace)، التي ترقى إلى التي ترقى إلى المستوى البشري، على مطابقة الوجوه مع تلك التي ظهرت في الصور التي تم تحميلها مسبقاً، بما في ذلك الصور المختلفة جداً سواء من حيث زاوية التصوير أو الإضاءة. كما تشارك شركة “جوجل” أيضاً في اللعبة، إذ لاحظنا الشهرة الجامحة لتطبيقها “الفنون والثقافة”، والذي يطابق صور السيلفي للمستخدمين مع صور من متاحف مختلفة من جميع أنحاء العالم. يمكن تشبيه الأمر، دون مزاح، بما هو عليه الحال في المتاجر الكبرى وسلاسل الوجبات السريعة.
إساءة استخدام التقنيات الحديثة
لكن بالإضافة إلى هذه التطورات السريعة من حيث الدقة، فإن هذه التقنيات الحديثة تحتوي أيضاً على احتمال سوء التفسير وإساءة الاستخدام. فمن ناحية أولى، لا تزال هذه الأنظمة الجديدة بعيدة عن الاعتماد عليها. ففي كل أسبوع، نسمع عن تقرير جديد لمستخدم تغلّب على فيس آي دي، تقنية “آبل” الجديدة التي يُفترَض أنها معصومة عن الخطأ، وهو الباحث المقنع من شركة الأمن السيبراني الفيتنامية، وهذا الطفل البالغ من العمر 10 سنوات الذي فتح هاتف أمه دون قصد، والمرأة الصينية التي ادّعت أنها قادرة على إلغاء قفل جهاز زميلها (الأمر الذي يعزوه البعض إلى نقص التنوع في التكنولوجيا). تذكّرنا هذه الأمثلة بضرورة التعامل مع التكنولوجيا باعتبارها عملية متواصلة تحتاج إلى تحسين مستمر. وإذا ألقينا نظرة إلى الوراء، نلاحظ فشل أسلاف ما قبل التكنولوجيا الرقمية للتقنيات الحديثة للتعرف على الوجوه لأننا أدركنا تحيزات مبدعي هذه التقنيات (مثل تصنيع الكاميرات والأفلام على النحو الأمثل للتعامل مع البشرة البيضاء فقط) وتطبيقاتها (مثل “علم” الفراسة). يمكننا أيضاً أن نرى فشل هذه التقنيات من خلال توصل الناس حتماً إلى طرق لاختراق الأدوات أو اختراق أجسادهم للتحايل عليها.
ومن ناحية أخرى، تترافق هذه التقنيات أيضاً مع احتمالات كبيرة في الظلم. ومع الانتشار الواسع للتكنولوجيات والتطورات في قوة الحوسبة خلال الوقت الراهن، ربما يكون هذا صحيحاً الآن أكثر من أي وقت مضى.
طوّر التقنيون الأنظمة المتقدمة جداً للعصر الرقمي. تم ذلك، على سبيل المثال، من خلال استغلال قواعد بيانات موسعة للمعلومات الشخصية – وهي معلومات لم يتم الحصول عليها بموافقة أصحابها دائماً. في عصر برتيلون، كان أولئك الذين يستخدمون أساليبه عادةً مقيدين بما يتوفر لهم من مشتبهين جنائيين، وكان لا بد لكل منهم أن يتم أخذ قياساته وتوثيقها بعناية، وكان يجب تخزين سجلاته يدوياً. أما الآن، فإن الوكالات الفيدرالية، مثل “مكتب التحقيقات الفيدرالي”، تبني قواعد بيانات ضخمة من الصور التي يتم التقاطها لأغراض غير إجرامية، مثل عمليات فحص خلفية الموظف أو لقطات كاميرات المراقبة. كما يتم تدريب برامج الذكاء الاصطناعي مثل برنامج “ديب فيس” لشركة “فيسبوك” على التغذية الهائلة للصور التي نحملها على الإنترنت.
كما أنه من الأسهل في الوقت الحالي تصنيف البيانات الحيوية الهائلة والبحث فيها ونقلها، وليس من الواضح دائماً ما يتم تشاركه بين الأجهزة الشخصية والشركات والهيئات المحلية والحكومية والتابعة للحكومة الفيدرالية. فكما كشفت الوثائق التي تسربت من قبل إدوارد سنودن، كانت وكالة “الأمن القومي” تجمع ملايين الوجوه من الويب كل يوم – من رسائل البريد الإلكتروني والنصوص ووسائل التواصل الاجتماعي ومؤتمرات الفيديو وغيرها الكثير – على أنها جزء من برامجها المتقنة للتعرف على الوجوه. كما أن الأخبار التي تفيد بأن شركة “آبل” ستشارك بعض بيانات “فيس آي دي” مع مطورين خارجيين، قد زادت من الشكوك حول هذه التقنية وإساءة الاستخدام المحتملة (على الرغم من ادعاء شركة “آبل”بعدم السماح للأطراف الخارجيين باستخدام المعلومات للإعلان أو التسويق أو التنميط). يثير هذا الأمر بالتحديد القلق إذا أخذنا بعين الاعتبار أننا ما نزال مجهزين على نحو سيئ بأفكار التصوير الفوتوغرافي التناظرية حول الخصوصية، حتى في الوقت الذي تعمل فيه الخوارزميات على جمع المزيد من الأشياء المثيرة للدهشة والمرعبة مما يتعلق بنا من خلال هذه الصور يومياً.
إلى متى ستستمر الضجة حول هذه الموجة الأخيرة من تقنيات التعرف على الوجوه؟ تصعب الإجابة عن هذا السؤال، على الرغم من أن ما نراه اليوم ليس سوى البداية فقط. لقد بدأت حكومتا الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بالفعل في مطالبة المسافرين الدوليين بإجراء فحصِ التعرّف على الوجوه في بعض المطارات الرئيسة. ومع النجاح المبكر لتقنية “فيس آي دي” من “آبل“، يبدو من المرجح أننا سنرى انتشار هذه الأنواع من الأنظمة في العديد من الأجهزة الشخصية. إذا أردنا استخلاص درس من التاريخ، فسنعلم أن الوقت الحالي هو الأنسب لإعداد وسائل حماية من سوء استخدام هذه التقنيات، وذلك لأن تقنية التعرف على الوجوه ستغير المستقبل.