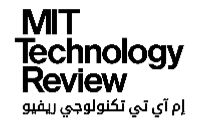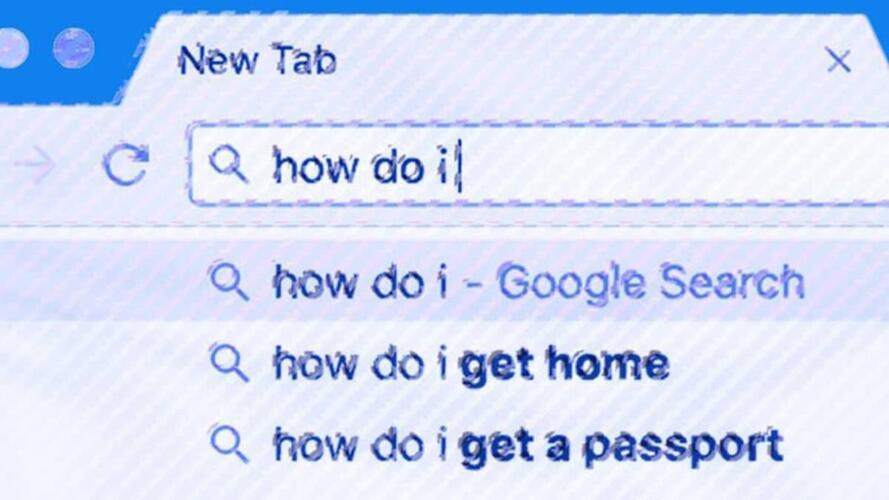
بإمكان خاصيّة الإكمال التلقائي وغيرها من الابتكارات التكنولوجية أن تغدو تنبؤات ذاتية التحقق. فماذا عن إمكانية تغيير المستقبل عبر التنبؤات؟
هل بمقدور الكمبيوترات التنبؤ بالمستقبل؟ قد ينشأ الانطباع بأننا، نحن البشر، نرغب بشدة بأن تقوم الكمبيوترات بذلك، إذا أحصينا العدد الهائل من قصص الخيال العلمي التي قرأناها على مدى عقود من الزمن والتي تصوّر العرّافين التكنولوجيين العالِمِين بكل شيء، مستخدمين طاقاتهم الحسابية الهائلة لأخذ كل تفصيل بالحسبان مهما كان صغيراً بالطريقة نفسها التي يتّبعها حاسوب “ديب بلو” من شركة “آي بي إم” للفوز بلعبة الشطرنج، أو برنامج “مايندز” الرائع لنمذجة سلوك حضارات بأكملها وهو يحسب احتمالات القفز إلى الفضاء الخارجي في الروايات الثقافية للكاتب “إيان بانكس”، أو الشخصية الآلية الخارقة “سي ثري بي أو” وهي تحسب احتمالات البقاء على قيد الحياة وتقدّمها للشخصية البشرية “هان سولو” في حرب النجوم.
عرّافو وادي السيليكون والتنبؤ بالمستقبل
أما ما نحن بصدده الآن فهو مختلف تماماً، إذ إن “عرّافي وادي السيليكون” لا يتنبؤون بالمستقبل البعيد كما تفعل “آلهة” الذكاء الاصطناعي، بل يتسللون إلى المستقبل القريب ويوسعون تدريجياً نطاق سلطتهم من خلال ما يطلق عليه مهندسو الكمبيوتر تعابير مختلفة ومتنوعة مثل “الاستشراف” و”التوقع” و”التنبؤ”، فالسيارات ذاتية القيادة تضغط على مكابحها قبيل ثوانٍ معدودة من وقوع الحادث، وتعمل برمجيات تداول الأسهم على استشراف تقلّبات السوق قبل حدوثها بأجزاء من الثانية، في حين تتوقع أدوات التنبؤ ذات الملكية المسجلة أغاني “البوب” وأفلام “هوليوود” القادمة التي ستلقى رواجاً كبيراً في الآتي من الأيام. وتُذكّرني الطرائق التي تتسلل من خلالها برمجيات الحوسبة إلى المستقبل بمقولة الكاتب ويليام باروز: “عندما تحدث شقاً في الحاضر، فإن المستقبل يتسرب منه”.
وعلى العموم، فإننا نشهد ظهور تنبؤات أفضل اللمستقبل القريب في مختلف أصناف المنتجات الاستهلاكية. وكم سخرنا من توصيات “أمازون” المضحكة ومن برنامج “كليبي” سيئ السمعة من “مايكروسوفت” الذي كان يظهر من وقت لآخر “ليساعدنا” في كتابة النصوص ببرنامج “وورد”! غير أن التنبؤات التي نشهدها هذه الأيام كثيراً ما تبدو دقيقة على نحو مخيف.
خاصية الإكمال التلقائي في “جوجل”
لنتأمل خاصية الإكمال التلقائي في “جوجل”، تلك العبارات الصغيرة المقترحة التي تظهر أمامك على الشاشة حالما تبدأ كتابة العبارة التي تبحث عنها في حقل البحث. ولو كان الحديث يدور عن أنماط النبوءات، لبدت هذه الخاصية نبوءة ضعيفة ومنقوصة. لكن تأمّل مدى اعتماد مستخدم الإنترنت العادي على هذه المقترحات بشكل يومي، وذلك ليس فقط لتوفير كتابة بضعة أحرف إضافية، بل بوصفها بحثاً صغيراً قائماً بذاته يهدف إلى التدقيق الإملائي السريع للعبارة المكتوبة، والتأكد من صحة المعلومة التي تتضمنها، والتعرف على مدى مطابقتها لروح العصر، كل ذلك في خطوة مدمجة واحدة. فهل يظهر الاسم الذي تبحث عنه مع كلمة “صديقة” أو “متزوجة”؟ وماذا يقترح عليك “جوجل” بعدما تكتب “كيف لي أن”؟ (فهو يقدم لك مشكوراً مقترحات مثل: “أجد طريقي إلى البيت، أجدّد جواز سفري، أحصل على جواز سفر، أنساك). تستند هذه التنبؤات جميعها على كلمات كتبها آلاف المستخدمين في حقول البحث على شاشاتهم، غير أنها أيضاً مصممة لك خصيصاً بالاستناد إلى سجل بحثك الخاص وموقعك الجغرافي وما إلى ذلك مما قد يكون “جوجل” قد جمعه عنك وأضافه إلى الملف الكبير الخاص بك لديه.
قد يبدو ذلك أمراً مريحاً وغير مقلق، بيد أنه يمثل أيضاً وسيلة لإعادة ابتكار علاقتنا بالحاضر وبالمستقبل القريب. فلقد أدرك محرك البحث “جوجل” منذ سنوات أن الناس ينزعجون من استطالة زمن الاستجابة، ولو لأقل من ثانية. وفي الواقع ينزعج الإنسان عموماً من الانتظار مهما كانت مدة الانتظار قصيرة ما دامت أطول من زمن استجابة جهازنا العصبي على المنبهات (والذي يبلغ حوالي 250 ميلي ثانية). فإذا أراد “جوجل” أن يجيب عن طلبك في الحال، فإنه يسعى إلى ذلك خلال المدة الزمنية التي يستغرقها قدمك ليبلّغ دماغك أن إصبع قدمك قد تلقى ضربة للتو. غير أن “جوجل” قد يخطو خطوة أبعد من ذلك من خلال توقع ما تريده وتقديمه لك حتى قبل أن تعبّر عنه. فعملية الإكمال التلقائي للكلمات التي تشرع في كتابتها تسارع إلى أن تقدم لك المستقبل القريب على طبق من فضة.
وتبدو النوعية التنبؤية للبرمجيات أكثر إثارة للاهتمام عندما تختار من بين خيارات الإكمال التلقائي التي تقترحها لك تلك البرمجيات، خياراً لا ينطبق تماماً على ما تبحث عنه وليكن (القطة) لكنه قريب منه (وليكن كلمة “القط” بوصفها تشبه كلمة القطة)، وذلك ليس لسبب سوى الكسل والاستسهال. ففي هذه الحالة التي كنت تبحث فيها عن مشاكل “القطة” ونقرت على مشاكل “القط”، يكون محرك البحث “جوجل” قد قام ليس فقط بتوقع المستقبل، بل بتغييره أيضاً. والآن اضرب هذا الاحتمال الصغير برقم 3.5 مليار أو أكثر (عدد طلبات البحث التي تعالجها شركة “جوجل” كل يوم) لترى خطورة الأمر.
وما عملية الإكمال التلقائي سوى واحدة من أمثلة كثيرة على طرائق تشكيل البرمجيات للمستقبل. خذ مثالاً آخر من علاقتك بموقع “فيسبوك” الذي صار مصدر الأخبار الرئيسي للكثيرين. يوظّف موقع التواصل الاجتماعي هذا كماً كبيراً من الموارد لجمع أكبر قدر ممكن من البيانات حولك والتنبؤ بما يناسبك من معلومات وصِلات لكي يقدمها لك ويضمن رجوعك إليه على الدوام. فهل أنت ليبرالي أم محافظ؟ غني أم فقير؟ ولأي فئة اجتماعية تنتمي؟ وأين موقعك الجغرافي؟ وما ماركات الملابس المفضّلة لديك؟ كما ترغب شركات الإعلان أن تعرف أيضاً –وهي تحاول دوماً استغلال قدرات “فيسبوك” المتطورة بشكل متزايد- كل شيء عن انتمائك الديموغرافي، وإمكانيات تأثيرك على الآخرين، وتفضيلاتك في المجالات كافة.
وهكذا مع تطوّر الإعلانات وتعزيز توجهها نحو الزبائن المستهدفين، تغدو أكثر تأثيراً في اختيارك للمنتجات التي تشتريها والهدايا التي تتلقاها والرحلات التي تذهبها والجوار الذي تنتقل للعيش فيه، وحتى في القرارات المصيرية التي تتخذها في حياتك مثل تغيير وظيفتك ودخولك القفص الزوجي. وعلاوة على ذلك تقترح البرمجيات الأشخاص الذين ستشاركهم الحدث المهم التالي في حياتك، وبالمقابل تقترحك لتشاركهم الأحداث المهمة في حياتهم.
غير أن البيانات المتوفرة عنك لدى “فيسبوك” قد تُستخدم أيضاً للتمييز ضدّك. بل من المحتمل أن يكون ذلك قد حدث فعلاً. إذ إن نظام “فيسبوك” الإعلاني القديم كان يسمح للزبائن باستثناء من ينتمون لفئات اجتماعبة بعينها بالاطّلاع على إعلاناتهم المرتبطة بالسكن والقروض والوظائف. وتدّعي شركة “فيسبوك” اليوم أنها تطبّق سياسات جديدة تمنع هذا النوع من الانحياز والتمييز. وبرمجيات “فيسبوك” قادرة على التمييز بين السمات الاجتماعية للمستخدمين بطريقة فعالة. وهكذا يقوم التطبيق بتضمين المعلومات المقدّمة لك، منشورات وإعلانات يظن أنك –أو بالأحرى أن صورتك غير الدقيقة التي قد يكون كوّنها عنك بطريقة غريبة- سوف تستمتع بها، بحيث تنطوي كل من هذه المنشورات والإعلانات على إمكانية تحولها إلى نبوءة ذاتية التحقق حول ما سيعجبك مستقبلاً.
أنواع تشكيل المستقبل
ومن الجدير بالملاحظة، أن المعلومات والأخبار المقدمة لك تشبه تلك المقدمة لمن يظن التطبيق أنهم يشبهونك اجتماعياً، وتختلف كثيراً عن تلك المقدمة لمن يظن أنهم ينتمون إلى فئات اجتماعية مختلفة عن فئتك. وهناك نوع آخر من أنواع تشكيل المستقبل، إذ يعمل التطبيق أيضاً على التلاعب بالمعلومات والأخبار التي نعيها- لا الأمور التي نركّز اهتمامنا عليها في الوقت الراهن فقط، بل ما يلوح أمامنا في الأفق أيضاً ولو بشكل مبهم وغير واضح تماماً. غير أن تلك الأمور الهامشية غالباً ما تعود إلينا وتُسهم في تشكيل مستقبلنا. فبما أن مقدرتنا في التفكير بالقرارات غير المرتبطة باللحظة الراهنة محدودة، فإن التقاط لمحة بطرف العين عن أمر ما –وليكن إعلاناً من شركة أحذية رياضية تروق لأصدقائك على “فيسبوك”- قد يؤثر في قراراتك المستقبلية، إذ إن ذلك الإعلان يضع الأحذية التي يروّج لها في مقدمة قائمة الأشياء التي قد ترغب في شرائها لاحقاً. كما من شأن ذلك أن يسهّل عليك اتخاذ قرار شراء أحذيتك الرياضية من تلك الشركة تحديداً (وهو أمر تعيه الشركة المعلنة جيداً).
إن ما تفعله تلك البرمجيات هو التسلل إلى نفوسنا، والتغلغل بين مشاعر الرضا والقلق فيها وملء ما بينهما من فجوات. فخاتم الخطوبة في ذلك الإعلان الموجّه إلينا على سبيل المثال، من المرجح أن يكون قريباً جداً مما في بالنا، بحيث يسهل علينا النقر عليه وشراؤه. غير أننا بفعلنا هذا نتحول إلى النسخة المسطّحة من ذواتنا التي تنبأت بها البرمجيات ونضيّق إمكانيات خبراتنا وتجاربنا في الحياة. وهكذا نتحول إلى ما يشبه الأرانب الكسالى.
ربما سيصبح هذا النوع من التنبؤات أكثر انتشاراً وجذباً مع الوقت بسبب توفيره لمزيد من الراحة مع تطور برمجياته ومع تنامي المعلومات الشخصية التي نزودها بها عن أنفسنا من خلال ما نبحث عنه وما نطرحه من تساؤلات وما نستخدمه من أجهزة ذكية في منازلنا، ومن خلال تحديث بياناتنا على وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى أرشيف الصور وأفلام الفيديو الخاصة بنا المتضخم يوماً بعد يوم. فها هي ذي شركة “فيسبوك” تسعى إلى قراءة أفكارك بكل ما تعنيه هذه العبارة من معنى. ففي مؤتمرها السنوي لمطوري برامجها، عرضت إحدى تقنياتها الجديدة القادرة على تحويل الأفكار إلى نصّ مكتوب مباشرة، وقدمت عرضاً مثيراً للاهتمام، غير أنها فتحت الباب أمام وابل من التساؤلات. ماذا لو كان النصّ المقترح، كما هو الأمر في حالة الإكمال التلقائي، شبيهاً فقط بما تفكر به، لا مطابقاً له؟ وماذا لو أعاد دماغك، الذي هو أداة قادرة على التأقلم بشكل مذهل، تشكيل طريقة تفكيره لتتطابق نتائجه مع نتائج التكنولوجيا الجديدة، فوجدت نفسك تفكر على طريقة “فيسبوك”، مثلما تجد نفسك تحلم باللغة الفرنسية لبضعة أسابيع قبيل خضوعك لاختبار تحديد المستوى المتقدم في هذه اللغة؟ إننا نستفيق اليوم على حقيقة أن احتمالات مستقبلنا التي يمكننا التفكير بها إنما تجري صياغتها عن طريق برمجيات يكتبها سوانا.
إنه نمط مبالغ فيه لكيفية تنبؤ أجهزة الكمبيوتر بالمستقبل، على أقل تقدير بالتفاصيل. غير أن ذلك يحدث دائماً إذا ما نظرنا إلى العموميات. فنحن نشرّح ونقطّع الحاضر إلى ملايين النماذج المختلفة ونضع أنواعاً مختلفة ومتعددة من الافتراضات حول ما يمكن وما لا يمكن توقعه. وكلما ازداد اعتمادنا على أجهزة الكمبيوتر للتعامل مع مستقبلنا القريب (إلى أي جهة أنعطف في الطريق؟ وماذا عليّ أن أقرأ؟ وبمن يُفترَض بي أن ألتقي؟)، ضاقت احتمالات خريطة حياتنا في الحاضر والمستقبل. وهكذا فإننا نعكس مقولة ويليام باروز لتصبح: إننا نقطّع المستقبل ونحوله إلى أجزاء صغيرة ملموسة في الحاضر، لكنها مصطنعة وتنقصها الجرعات الطبيعية من الطموح والغموض والشك، وتفتقد للأهداف الإنسانية العميقة”. قد نتلقى بمساعدة التكنولوجيا الحديثة أجوبة لأسئلتنا، غير أننا لا ندرك المعنى الحقيقي لتلك الأجوبة.
البرمجيات ورسم مستقبلنا القريب
وبالنسبة لغالبيتنا، فإن ما يهمّنا معظم الوقت ليس ما سيحدث في المستقبل البعيد والمبهم، بل ما سيحدث في الدقائق الخمس المقبلة، أو في اليوم التالي، أو في مضمون السطر التالي من رسائل التواصل. وهذا ما تعمل البرمجيات على التنبّؤ به واقتراحه علينا لأنه هو ما سيصوغ القرارات الحقيقية التي ستدفع بعجلة حياتنا إلى الأمام. غير أن المستقبل لا يتوقّف على القرارات المستقبلية ذات الصلة بالمستقبل المنظور فحسب، بل يتحدّد في جوهره من خلال المساحة الفارغة على الخريطة، المساحة المرتبطة بالاحتمالات والآمال. وفي الأيام الجميلة، يتجسد المستقبل الحقيقي في منظار التلسكوب الذي نرى من خلاله أفضل ما يكمن في أنفسنا يظهر إلى الواقع في النهاية.
قد تبدو البرمجيات جذابة ومقنعة لدرجة أننا نترك لها مهمة رسم تفاصيل مستقبلنا القريب، فتقوم أيضاً بطمس التغييرات البطيئة والدراماتيكية التي تستغرق عقوداً وإخفائها لتنضج وتصبح واضحة. فهذه البرمجيات فعّالة جداً في ملء كل لحظة من أوقات فراغنا بالمقترحات والمعلومات والتحديثات التي تعكّر سكينتنا وتقضي على أي فرصة حيوية للتأمّل والشرود مع أحلام اليقظة والتفكير بالذات: تلك اللحظات التي نكتشف فيها فجأة أنه علينا تغيير عملنا أو تأليف كتاب جديد أو تغيير شخصيتنا. ولعلّنا جميعاً قد اختبرنا مثل هذه اللحظات التي اكتشفنا فيها نسخاً جديدة كلياً عن ذواتنا لم نكن لنتوقعها بمساعدة أي برمجيات مهما كانت متطورة. ولا يجدر بنا أن نترك مستقبلنا لتلك البرمجيات تتلاعب به على هواها.
وفي نهاية الحديث عن تغيير المستقبل عبر التنبؤات، إن احتمالات المستقبل التي تفكر فيها وتفصح عنها، إنما يجري تشكيلها من خلال برمجيات أشخاص آخرين.